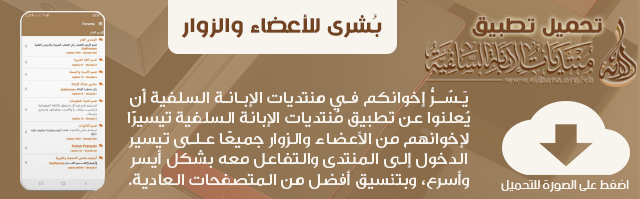بسم الله الرحمن الرحيم
قواعد في التّعامل بالسّنّة
للشيخ عبد السلام بن برجس
رحمه الله
قواعد في التّعامل بالسّنّة
للشيخ عبد السلام بن برجس
رحمه الله
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون﴾[سورة آل عمران: الآية ١٠٢].
﴿يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا﴾ [سورة النساء: الآية ١].
﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا (٧٠) يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما﴾ [سورة الأحزاب ]
أما بعد:
فهذا جمع منّي لبعض قواعد للتعامل مع السنة لشيخنا عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله نقلته من رسالته:
"ضرورة الاهتمام بالسنن النبوية".
أشارك به إخواني الفضلاء في زمن الغربة وكثرة الفتن وانتشار البدع والأهواء.
نسأل الله الثبات والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى.
ــــ * ــــ
قال رحمه الله:
القاعدة الأولى:
يعمل بالسّنّة ولو هجرها النّاس.
كثيرا ما يحصل عند بعض المحبّين للسنة تردد في إحياء سنة لا وجود لها في مجتمعه، يدفعه إلى ذلك خجل، أو نحو ذلك.
ألا فليعلم هؤلاء أن إحياءهم السنة في هذه الحالة أفضل بأضعاف مضاعفة من العمل بها في مجتمع متمسك بالسنة.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: «إن من ورائكم أيام الصبر، للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر خمسين منكم»، قالوا: يا نبيّ الله أومنهم؟ قال: «بل منكم».
وما أحسن ما قاله الشيخ سليمان بن سحمان في ردّه على من أنكر سنة رفع الصوت بالذّكر بعد السلام: «فلو كان كل ما ترك من السنن القولية والفعلية، مما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم -مما تساهل الناس بترك العمل به، من الأمور التي يثاب الإنسان على فعلها، ولا يعاقب على تركها- إذا أخبر بها مخبر أنّها سنّة مهجورة غير معمول بها: أنّ المخبر بذلك مشوّش على النّاس إذا عمل به … لانسدّ باب العلم، وأميتت السّنن؛ وفي ذلك من المفاسد ما لا يحصيه إلا الله». اهـ
ولقد صدق؛ فأيّ مفسدة أعظم على أهل الإسلام والسّنّة من موت سنّة كانت من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتّى لا تعلم الأجيال بها، ولو فعلت عندهم لأنكروها.
وقد روى الخطيب في «الفقيه والمتفقه»: أنّ عبد الله بن الحسن يكثر الجلوس إلى ربيعة، قال: فتذاكروا يوما السّنن، فقال رجل كان في المجلس: ليس العمل على هذا. فقال عبد الله: أرأيت إن كثر الجهّال حتى يكونوا هم الحكّام أفَهُم الحجة على السنة؟! فقال ربيعة: أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء. اهـ.
وما موت السنة إلا علامة ظهور البدع وفشوها؛ كما قال ابن عباس رضي الله عنه: «ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة، وأماتوا فيه سنة، حتى تحيا البدع وتموت السنن». [رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها]
وترك السّنن يفضي إلى عدم معرفتها.
قال شيخ الإسلام في [مجموع فتاوي (٤/٤٣٦)]: «يجوز ترك المستحب من غير أن يجوز اعتقاد ترك استحبابه؛ ومعرفة استحبابه فرض على الكفاية؛ لئلا يضيع شيء من الدين». اهـ .
ورحم الله ابن القيّم إذ يقول في كتابه: [إعلام الموقعين ٢\٣٩٥]: «ولو تركت السنن للعمل لتعطلت سنن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ودرست رسومها وعفت آثارها. وكم من عمل قد اطّرد بخلاف السّنّة الصّريحة على تقادم الزمان، وإلى الآن. وكل وقت تترك سنة، ويعمل بخلافها، ويستمر عليها العمل، فتجد يسيرا من السنة معمولا به على نوع تقصير. وخذ ما شاء الله من سنن قد أهملت، وعطل العمل بها جملة فلو عمل بها من يعرفها لقال الناس: تركت السنة …»
فالله الله يا أمة الإسلام في سنن رسولكم صلى الله عليه وسلم؛ من لها سواكم؟ أحيوها جهدكم، وأرشدوا الناس إلى العمل بها، فهي عنوان المحبّة الكاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلامة المتابعة الصادقة له صلى الله عليه وسلّم.ولا يجرمنّكم شنآن المتعصبين، ولا تهويل المبطلين، ولا حيصة العوام المفتونين، فإنّ السّنة اليوم غريبة، معاول الهدم تخدشها من كل جانب، فهي اليوم في أشد الحاجة إلى أبنائها المخلصين، الذين يتحملون في سبيلها المشاق، ويؤثرونها على حظوظ أنفسهم، قائدهم في ذلك الرفق واللين، والمجادلة بالتي هي أحسن، وسيكون التوفيق حليفهم، والعاقبة الحسنى لهم، متى ما أخلصوا النية لله واحتسبوا منه وحده الثواب على هذا العمل الجسيم.
وما أحوجنا هنا أن نذكرهم بتلك التجربة التي جرت على يد الإمام الشاطبي عندما عقد العزم على إحياء السنة والتجرد لها وإن خالفها الناس، فتعرض بسبب ذلك لمقت الناس، وإزرائهم به، واتهامه بكل سوء ولكن العاقبة للمتقين
قال تعالى: ﴿ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز﴾.
قال الشاطبي في «الاعتصام»: «… فتردد النظر بين أن أتبع السنة على شرط مخالفة ما اعتاد الناس؛ فلا بد من حصول نحو مما حصل لمخالفي العوائد -لا سيما إذا ادعى أهلها أن ما هم عليه هو السنة لا سواها- إلا أن في ذلك العبء الثقيل ما فيه من الأجر الجزيل. وبين أن أتبعهم على شرط مخالفة السنة والسلف الصالح، فأدخل تحت ترجمة الضلال -عائذابالله من ذلك- إلا أني أوافق المعتاد، وأعد من المؤالفين لا من المخالفين. فرأيت أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة، وأن الناس لن يغنوا عني من الله شيئا …». اهـ.
القاعدة الثانية:
تبين السّنّة ولا يخاصم عليها؛ والمقصود بالمخاصمة الجدل المورث للضّغائن، ولاشكّ أنّ هذا الجدل عقاب من الله تعالى، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه: «ما ضل قوم بعدي …… كانوا عليه إلا أوتواالجدل» [رواه أحمد وغيره عن أبي أمامة]، وقد كثرت عبارات الأئمّة في التّحذير من الجدل وبيان آفاته.
حتّى قال الإمام مالك: «الجدال في الدّين ينشىء المراء، ويذهب بنور العلم من القلب، ويقسي، ويورث الضغن» [سير أعلام النبلاء ٨/١٠٦]
فعلى طالب الهدى أن يبين للناس السنة، ويقيم عليها الحجج، ويتخذ في سبيل ذلك: أسلوب الإقناع، فإن لم يقبل منه «فما على الرسول إلا البلاغ المبين».
وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: «أخبر بالسنة، ولا تخاصم عليها» [طبقات الحنابلة].
وقال الهيثم بن جميل، قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله، الرجل يكون عالما بالسّنّة؛ أيجادل عنها؟ قال: «لا، ولكن يخبر بالسنة، فإن قبلت منه وإلا سكت». اهـ [جامع بيان العلم وفضله]
وهذا كله في المخاصمة المذمومة، التي تنشأ عنها المفاسد، حتى تتلاشى المصلحة في جنبها.
أما المجادلة بالتي هي أحسن، وهي: ما كان الحق فيها هدفا للطرفين، ولم تشتمل على ما يخرجها عن هذا المقصد: فنِعِمّا هي، تبيّن الحقّ، وتهدي السّبيل، وترشد إلى مواطن الصّواب، وإذا حصلت المناظرة فحذار أن تكون سببا للشقاق والنزاع، والعداوة بين الإخوان، وقل أن تخلو مناظرة من هذا، نسأل الله العافية والسلامة.
قال يونس الصفدي: «ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، ولقيني فأخذ بيدي، ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟». قال الذهبي تعليقا على هذه الحادثة: «قلت: هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام، وفقه نفسه، فما زال النظراء يختلفون». اهـ [سير أعلام النبلاء ١٠/١٦-١٧]
وأخرج ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»: عن العبّاس بن عبد العظيم العنبري: قال: «كنت عند أحمد بن حنبل، وجاءه عليّ بن المديني راكبا على دابة؛ قال: فتناظرا في الشهادة، وارتفعت أصواتهما، حتى خفت أن يقع بينهما جفاء، وكان أحمد يرى الشهادة، وعلي يأبى ويدفع؛ فلما أراد علي الانصراف: قام أحمد، فأخذ بركابه». اهـ.
قال شيخ الإسلام: «وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول …﴾ الآية. وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة، وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وإخوة الدين. نعم: من خالف الكتاب المستبين، والسنة المستفيضة، وما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه: فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع». اهـ [مجموع الفتاوي ٢٤\١٧٣].
وقد نعى شيخ الإسلام -على أولئك الذين يتعصبون لما يرونه من السنن الاجتهادية ويعادون من خالفهم فيها- فقال: «وأما التعصب لهذه المسائل ونحوها فمن شعائر الفرقة والاختلاف الذي نهينا عنه؛ إذ الداعي لذلك هو ترجيح الشعائر المفترقة بين الأمة، وإلا فهذه المسائل من أخف مسائل الخلاف جدا، لولا ما يدعو إليه الشيطان من إظهار شعار الفرقة». اهـ [المصدر السابق]
القاعدة الثالثة:
الموازنة بين المصالح والمفاسد
القاعدة الشرعيّة؛ أنّه: «إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما»، ونظيرها: «درء المفاسد أولى من جلب المصالح».
فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا «إلا أن تكون المفسدة مغلوبة» لأنّ اعتناء الشّارع بالمنهيّات أشدّ من اعتنائه بالمأمورات [الاشباه والنظائر للسيوطي].
وأدلّة هذه القاعدة في الشّريعة كثيرة.
منها ما اتفق عليه الشّيخان -واللّفظ لمسلم- من حديث عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر؟ أمن البيت هو؟ قال: «نعم»، قلت: فلم لم يدخلوه في البيت؟ قال: «إن قومك قصرت بهم النفقة»، قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: «فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاؤوا، ويمنعوا من شاؤوا؛ ولولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم: لنظرت أن أدخل الجدر في البيت،وأن ألزق بابه بالأرض».
وقد بوب البخاري على حديث عائشة، فقال: «باب ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه». اهـ.
قال الحافظ في «الفتح»: «ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة». اهـ.
قال شيخ الإسلام في معرض ذكر بعض المستحبات: «ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات، لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا، كما ترك النّبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت لما في إبقائه من تأليف القلوب، وكما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة في السفر، ثم صلى خلفه متما، وقال: الخلاف شر». اهـ [أخرجه البخاري في العلم ١\٢٢٤].
وقال في موضع آخر: «فالعمل الواحد يكون فعله مستحبا تارة، وتركه تارة، باعتبار ما يترجح من مصلحة فعله وتركه، بحسب الأدلة الشرعية.والمسلم قد يترك المستحب إذا كان في فعله فساد راجح على مصلحته، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم … فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الذي كان عنده أفضل الأمرين للمعارض الراجح، وهو: حدثان عهد قريش بالإسلام، لما في ذلك من التنفير لهم، فكانت المفسدة راجحة على المصلحة.ولذلك استحب الأئمة: أحمد وغيره: أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل إذا كان فيه تأليف المأمومين، مثل أن يكون عنده فضل الوتر أفضل بأن يسلم في الشفع ثم يصلي ركعة الوتر، وهو يؤم قوما لا يرون إلا وصل الوتر، فإذا لم يمكنه أن يتقدم إلى الأفضل كانت المصلحة الحاصلة بموافقته لهم بوصل الوتر أرجح من مصلحة فصله مع كراهتهم للصلاة خلفه. وكذلك لو كان ممن يرى المخافتة بالبسملة أفضل أو الجهر بها، وكان المأمومون على خلاف رأيه، ففعل المفضول عنده لمصلحة الموافقة والتأليف التي هي راجحة على مصلحة تلك الفضيلة كان جائزا حسنا». اهـ .
وكلّ ما قرّرته تحت هذه القاعدة، لا ينفي ما سبق بيانه من العناية بالسّنّة، والحرص عليها.
فإنّ هذه القاعدة إنما سيقت لأمر عارض، لا أن تقتل السنة، وتدفن من أجلها.فإذا ما تمسك بها من يرى أن السنة عائق من عوائق تصحيح المسار - باعتبار أنها جالبة للخلاف والنزاع - فإننا نرد عليه: بأن ترك السنة بالكلية مفسدة عظيمة، بها يضيع شيء من شرع الله تعالى، وقد قال عبد الله بن مسعود : «يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا - يعني مفصل الإصبع - فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى، وإنه لم يكن أهل كتاب قط إلا كان أول ما يتركون السنة، وإن آخر ما يتركون الصلاة، ولولا أنهم يستحيون لتركوا الصلاة». [رواه اللالكائي في «شرح اعتقاد أهل الحديث» ١/ ٩١].
إذا فالمفهوم الصحيح للقاعدة: أنه إذا ترتب على إظهار سنة من السنن مفسدة راجحة على مصلحة إظهار السنة، فيكف عن السنة في هذا الموطن، مع مراعاة ما يلي:
أولا: وجوب المناصحة، والتذكير بعظم السنة، وكبير مكانها.
ثانيا: ألا تترك السنة إلى الأبد.
ثالثا: إذا علم من حال المشوش على إقامة السنة، أنه إنما دفعها رغبة عنها، إما تعصبا لمذهب، أو اتباعا لمنهج، فإن السنة تقام -وإن رغم أنفه وأنف ألف مثله-؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: «… ومن رغب عن سنتي فليس مني».
والمصلحة الكبرى التي كنّا نريد إبقاءها، إنمّا هي: المودّة بين أهل السّنّة، وتلافي وقوع البغضاء والعداوة بينهم، فلمّا كان هذا الرجل أو هذه الجماعة راغبين عن السنة، سقطت مودتهم، ووجب هجرهم وكراهتهم في الله تعالى.
وهذا بخلاف من كان جاهلا -ككثير من العامّة- فإن ترك السّنّة درءا لجهله على القائم بها، أو الوقوع في شيء من محظورات الألفاظ، أمر مطلوب، حتى يعلم برفق ويستعان عليه بمن يثق به من أهل العلم، فإن أصر بعد ذلك؛ فألحقه بإخوانه السابقين، أهل البدع.
القاعدة الرابعة:
هل في المسائل الاجتهادية إنكار؟
الكلام على مثل هذه القضيّة يحتاج إلى مؤلَّف مستقل، إلا أننا هنا نختصر قدر ما يحصل به البيان، فنقول: يخطئ كثير من الناس حينما يعتقدون أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، ولذا وقعوا في مزلق خطير، حيث قالوا: «إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها»! وهذا باطل من القول، يلزم عليه من اللّوازم الفاسدة ما يعطل جملة كبيرة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وقد أجاد العلامة ابن القيم -في رد هذه المقولة في كتابه «إعلام الموقعين»- حيث قال: «وقولهم: «إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها» ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى، أو العمل:
أما الأول: فإذا كان القول يخالف سنة، أو إجماعا شائعا: وجب إنكاره اتفاقا، إن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله.
وأما العمل: فإذا كان على خلاف سنة، أو إجماع: وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار.
وكيف يقول فقيه: لا إنكار في المسائل المختلف فيها، والفقهاء في سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء؟
وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع، وللاجتهاد فيها مساغ: لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا.
وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم.
والصواب ما عليه الأئمة: أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا مثل حديث صحيح لا معارض له جنسه فيسوغ فيها - إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به - الاجتهاد: لتعارض الأدلة، أو لخفاء الأدلة فيها.
وليس في قول العالم: «إن هذه المسائل قطعية أو يقينية ولا يسوغ فيها الاجتهاد»، طعن على من خالفها، ولا نسبة له إلى تعمد خلال الصواب.
والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقنا صحة أحد القولين فيها كثير:مثل كون الحامل تعتد بوضع الحمل، وأن السنة في الركوع وضع اليدين على الركبتين دون التطبيق، وأن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه سنة … إلى أضعاف أضعاف ذلك من المسائل.
ولهذا صرح الأئمة: بنقض حكم من حكم بخلاف كثير من هذه المسائل، من غير طعن منهم على من قال بها.وعلى كل حال: فلا عذر عند الله يوم القيامة لمن بلغه ما في المسألة من هذا الباب وغيره من الأحاديث والآثار التي لا معارض لها إذا نبذها وراء ظهره، وقلد من نهاه عن تقليده، وقال له: لا يحل لك أن تقول بقولي إذا خالف السنة …». اهـ كلامه رحمه الله؛ وهو في غاية الوضوح والإتقان.
وإن من المعلوم عند أهل العلم: أن المسائل الشرعية قسمان:
- قسم مجمع عليه.
- وآخر مختلف فيه.
والمختلف فيه درجات، فمنه ما يعود الخلاف فيه إلى اللفظ، ومنه ما يكون أحد جانبي الخلاف فيه واضح الضعف والسقوط: فلا ريب هنا أنه يجب إنكار القول الضعيف ونقض حكم من حكم به من القضاة.
ومن مسائل الخلاف: تلك المسائل التي تتقارب فيها المدارك وتتكافأ فيها الأدلة، ويكون الحكم موكولا إلى الاستنباط من النص الشرعي، وهذا هو المعروف بالمسائل «الاجتهادية» والحكم فيها:
أ- التناصح بين المختلفين، ويكون بالمناقشات العلمية المثمرة للصواب، وبيان وجهة وحجة كل قول.
ب- إذا لم يقنع أحد الجانبين بحجة الآخر وجهته، فلا يكون ذلك داعيا إلى التغليظ والإنكار والفرقة.
ج- إذا كان عدم الاقتناع مبنيا على غير حجة، كأن يكون لتعصب مذهبي، أو هوى، أو نحو ذلك، فيغلظ وينكر على صاحبه، إذ العبرة في المخالفة بالحجة، لا بسواها.
ومن أمثلة هذه المسائل الاجتهاديّة ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى في أصحابه يوم انصرف عن الأحزاب: «أن لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة»، فتخوّف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فاتنا الوقت.
قال: فما عنف -أي النبي صلى الله عليه وسلم- واحدا من الفريقين. هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري «العصر» بدل «الظهر».
ففي هذا الحديث نرى اختلاف الصحابة في فهم النص الذي سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فاكتفى كل فريق بذكر مستنده في توجيه النص ودلالته، فلما لم يقنع كل واحد من الفريقين بفهم صاحبه عمل كل واحد منهما بما تبين أنه الحق عنده. ولم يحصل لوم ولا تعنيف من بعضهم لبعض، ولا من صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم لهم.
وهذا له نظائر كثيرة -في المسائل الاجتهادية- في سير الصحابة وتابعيهم يطول حصرها. وفي مثل هذه المسائل يقول سفيان الثوري رحمه الله: «إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه» [الفقيه والمتفقه].
ويقول يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله: «ما برح ألو الفتوى يفتون، فيحل هذا، ويحرم هذا، فلا يرى المحرم أن المحل هلك لتحليله، ولا يرى المحل أن المحرم هلك لتحريمه» [جامع العلم وفضله لابن عبد البر].
وجاء في «كشف الخفا»: أنّ الخطيب أخرج في «رواة مالك» عن إسماعيل بن أبي المجالد، قال: قال هارون الرشيد لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله نكتب هذه الكتب -يعني مؤلفات الإمام مالك- ونفرقها في آفاق الإسلام لنحمل عليها الأمة؟ قال: يا أمير المؤمنين! إنّ اختلاف العلماء رحمة من الله تعالى على هذه الأمة، كل يتبع ما صح عنده، وكل على هدى، وكل يريد الله تعالى. اهـ.
وهذه الكلمات وأمثالها محمولة على المسائل الاجتهادية؛ لأنّ واقع من قالها، وغيره من السّلف: الإنكار على من أخطأ في الفتوى والأحكام، إلا ما كان من المسائل الاجتهاديّة فيقتصر على المناقشات والمناصحة.
قال ابن القيم رحمه الله: «… بل عند فقهاء الحديث: أن من شرب النبيذ المختلف فيه: حد، وهذا فوق الإنكار باللسان. بل عند فقهاء أهل المدينة: يفسق، ولا تقبل شهادته. وهذا يرد قول من قال: «لا إنكار في المسائل المختلف فيها». وهذا خلاف إجماع الأئمة، ولا يعلم إمام من أئمة الإسلام قال ذلك …» اهـ.
ولنقتصر على مثال واحد مما ذكره ابن القيم فبهتوا وانقطعت حجتهم». اهـ
القاعدة الخامسة:
لا يعمل بما ورد حتى يثبت رواية ودراية إذا نقلت إلينا سنة، فإن الواجب علينا -قبل العمل بها- أمران:
الأول: التّأكد من صحّة سندها، إما بإعمال القواعد الحديثة على إسنادها لمن كان أهلا لذلك، وإمّا بتقليد أحد أئمّة هذا الشأن.
قال الشّيخ زكريا بن محمد الأنصاري في كتابه «فتح الباقي على ألفية العراقي»: «طريق من أراد الاحتجاج بحديث من السنن أو المسانيد: أنه إن كان متأهلا لمعرفة ما يحتج به من غيره فلا يحتج به حتى ينظر في اتصال إسناده، وحال رواته وإلا فإن وجد أحدا من الأئمة صححه أو حسنه فله تقليده، وإلا فلا يحتج به». اهـ
فالعمل بالحديث دليل على الاحتجاج به، ولا سبيل إلى الاحتجاج به إلا إذا علم ثبوته.
وأمّا ما لا يثبت فلا يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا به، كما قال شيخ الإسلام: «ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة، لكن أحمد بن حنبل، وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت، إذا لم يعلم أنه كذب، وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقا، ولم يقل أحد من الأئمة: إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع». اهـ
قال شيخ الإسلام -أيضا-: «قول أحمد بن حنبل: إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد، وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد، وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؛ ليس معناه: إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به؛ فإن الاستحباب حكم شرعي، فلا يثبت إلا بدليل شرعي.
ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم، ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب، كما يختلفون في غيره، بل هو أصل الدين المشروع.
وإنما مرادهم بذلك: أن يكون العمل مما قد ثبت أنه ممايحبه الله، أو مما يكرهه الله بنص أو إجماع، كتلاوة القرآن، والتسبيح، والدعاء، والصدقة، والعتق، والإحسان إلى الناس، وكراهية الكذب، والخيانة، ونحو ذلك.
فإذا روي حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها، وكراهة بعض الأعمال وعقابها: فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روى فيه حديث - لا نعلم أنه موضوع - جازت روايته، والعمل به؛ بمعنى: أن النفس ترجو ذلك الثواب، أو تخاف ذلك العقاب …» اهـ
وقد لخص العلامة الألباني حفظه الله في مقدمة «صحيح الترغيب والترهيب» كلام شيخ الإسلام -هذا- فقال: «ونستطيع أن نستخلص منه أن الحديث الضعيف له حالتان: الأولى: أن يحمل في طواياه ثوابا لعمل ثبت مشروعيته بدليل شرعي، فهنا يجوز العمل به، بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب، ومثاله عنده: التهليل في السوق بناء على أن حديثه لم يثبت عنده … والأخرى: أن يتضمن عملا لم يثبت بدليل شرعي، يظن بعض الناس أنه مشروع، فهذا لا يجوز العمل به.
وقد وافقه على ذلك العلامة الأصولي المحقق الإمام أبو إسحاق الشاطبي الغرناطي في كتابه العظيم: «الاعتصام»…اهـ .
ولعل في هذا القدر من كلام شيخ الإسلام ما يصحح الخطأ الشائع عند جماعة من أهل العلم وطلابه، حيث يفهمون قول العلماء في الحديث الضعيف فهما لا يتفق مع ما أرادوه.
الأمر الثاني: التأكد من صحة الاستنباط، وسلامة الاستدلال، وفقا للقواعد الأصولية المعتبرة.
فإن بعض الناس قد يوفق لمعرفة الصحيح من الضعيف، إلا أن التوفيق لا يحالفه في استخراج الحكم الشرعي من النص، وهنا تكمن الرزية.
فعلى طالب العلم أن يراعي هذا الجانب، وذلك بالرجوع إلى شروح أهل العلم على الحديث، وسؤالهم عنه، وعن دلالته، حتى لا يقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يشعر؛ فإن من نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما من الأحكام لم يقتضه كلامه فقد كذب عليه، إلا أن يكون من أهل الاجتهاد وبذل قصارى جهده فلم يصب الحق؛ فإنه مأجور غير مأزور.
وإنما الكلام في أولئك الذين ليس لديهم ما يؤهلهم للنظر في كلام الشارع، استنباطا واستدلالا؛ ثم يخوضون هذا البحر العميق، دون مراكب تحملهم، فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه، وأنزلها منزلها.
قال معاوية رضي الله عنه: «إن أغرى الضلالة لرجل يقرأ القرآن فلا يفقه فيه، فيعلمه الصبي، والعبد، والمرأة، والأمة، فيجادلون به أهل العلم».
وقال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله: «ليكن الذي تعتمد عليه الأثر، وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث». اهـ.
وقيل لبعض الحكماء: «إن فلانا جمع كتبا كثيرة، فقال: هل فهمه على قدر كتبه؟ قيل: لا، قال: فما صنع شيئا»، قال الخطيب البغدادي رحمه الله -تعليقا على هذه الحكاية ونحوها-: «وهذه حال من اقتصر على النقل إلى كتابه من غير إنعام النظر فيه، والتفكر في معانيه». اهـ [الفقيه والمتفقه].
فنسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويررزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه
كما نسأله سبحانه أن يرحم شيخنا عبد السلام البرجس وسائر علمائنا
كما نسأله سبحانه أن يحفظ الأحياء منهم وأن يبارك فيهم
إنه ولي ذلك والقادر عليه
وصلى الله وسلم وبارك على
نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم
وآله وصحبه
أجمعين
*
كما نسأله سبحانه أن يرحم شيخنا عبد السلام البرجس وسائر علمائنا
كما نسأله سبحانه أن يحفظ الأحياء منهم وأن يبارك فيهم
إنه ولي ذلك والقادر عليه
وصلى الله وسلم وبارك على
نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم
وآله وصحبه
أجمعين
*
_________________________________
نقله: أبويونس طارق العنابي يوم 5 من شعبان 1442هجري
نقله: أبويونس طارق العنابي يوم 5 من شعبان 1442هجري